مارسيل بروست – طـه حسين:
ما لا تقوله اللغة
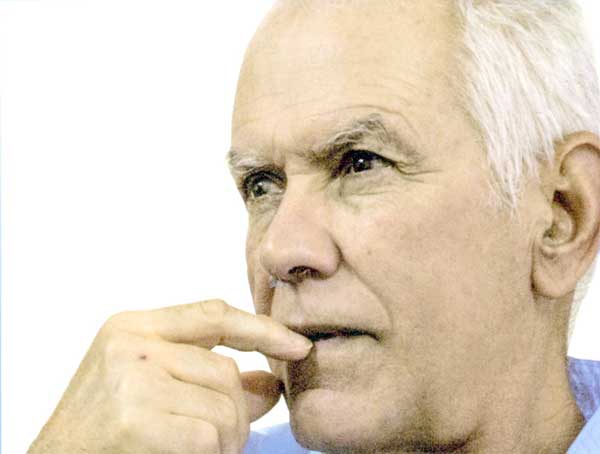
- 1330
 بقلم: مرزاق بقطاش
بقلم: مرزاق بقطاش
"لقد وضعت كلمة "الختام"، وفي مقدوري الآن أن أموت مرتاحا!". تلك آخر جملة قالها مارسيل بروست (Marcel Proust (1922-1871 لخادمته الأمينة سيلست ألباري (Céleste Albaret) قبيل أن يلفظ الروح. وبالفعل، حين دخلت عليه خادمته على جري عادتها في الصباح الباكر، كان قد انتهى لتوه من روايته النهرية "بحثا عن الزمن الضائع" (A la recherche du temps perdu) وتصف خادمته حالته النفسية في تلك اللحظات فتقول عنها إنها كانت عبارة عن "سرور غامر" لم يسبق لها أن خبرتها لدى مارسيل بروست الذي كانت تناديه بـ"السيد". أما الأديب فرانسوا مورياك (François Mauriac 1885-1970)، فقال عنه إن "عمله الإبداعي هو الذي قضى عليه تماما مثلما قتل قبله "هونوري دو بلزاك Honoré de Balzac (1850-1799). كان بروست قد انتهى أمضى سنوات طويلة من حياته في تدوين روايته، معانيا وطأة داء الربو الذي حال بينه وبين التنفس الطبيعي وذلك ما أجبره على الاعتكاف في غرفة مبلطة بالفلين حتى لا تتسرب أدنى نسمة فتزلزل وتيرة التنفس التي كان يحرص عليها الحرص كله. وهذه العزلة بالذات هي التي أفسحت المجال دونه لكي يصوغ روايته على هواه مستعيدا عبرها أيامه الخوالي وما يسمى بـ"الفترة الجميلة "La belle époque" في تاريخ المجتمع الفرنسي بدءا مابين 1880 و 1913.
هل قضى عليه الإبداع الأدبي حقا، أم إنه أطال عمره؟ إذا كان قرينه العربي،- في جانب آخر -، ونعني به الدكتور طه حسين (1889-1973) قد سار على نهجه في مضمار السرد القصصي، مع فارق كبير بينهما، بدءا من سيرته الذاتية "الأيام" ومرورا بـ"أديب" و"المعذبون في الأرض" و"دعاء الكروان"، فإنه لم يبد عليه أنه تأثر به على الرغم من أنه كان على اطلاع دقيق بتحف الأدب الفرنسي. لكن، يمكن القول إنه حذا حذوه في الجانب الأسلوبي، أي، في النفس الطويل الذي تميزت به جملته العربية الأنيقة.
لكأننا بكل من هذين الأديبين العملاقين قد سارا في خط واحد على صعيد الأسلوب. مارسيل بروست يأخذ بأسباب الجملة الطويلة ولا يكاد يضع نقطة النهاية في هذه الجملة أو تلك إلا بعد أن يشعر بالحاجة إلى أخذ نفس جديد، متكئا في ذلك على الجانب الإيقاعي الذي يحسن التحكم فيه بحيث لا يكاد القارىء ينفر من أسلوبه، بل يسايره وكأنه قبالة جدول رقراق ينساب هادئا، معرجا على هذه الصخرة أو تلك، مدللا بذلك على نفسية الكاتب بالذات. وهل من عجب إذا ما عرفنا أن مارسيل بروست هو صاحب أطول جملة نثرية في الأدب الفرنسي بحيث إنها بلغت 243 كلمة؟ ولكأننا أيضا بطه حسين يفعل نفس الشيء دون أن يبعث قارئه على الملل أو النفور من أسلوبه، سواء أكتب الرواية أم عالج البحث الاجتماعي- التاريخي أم النقد الأدبي.
حين نتمعن في التقنية الأسلوبية لدى هذين الأديبين نجد أنفسنا مدفوعين إلى القول إن المرض الذي أصيب به مارسيل بروست منذ صباه الأول، أي، داء الربو، وعاهة العمى التي مني بها طه حسين منذ سن الثالثة، هما في كلتا الحالتين وراء ميلهما التلقائي إلى الأخذ بنفس الأسلوب السردي، أي الجملة الطويلة.
تمكن طه حسين من علوم العربية بطريقة كلاسيكية، أي عن طريق السماع. وفي هذا الجانب على وجه التحديد ساعده فقدان بصره على امتلاك ناصية اللغة العربية وفقا للطريقة المعتمدة في التراث العربي القديم، بمعنى أنه ما كان يشعر بالحاجة إلى استخدام أسباب التنقيط المعروفة التي فرضت نفسها في اللغة العربية منذ أن دخلت المطبعة إلى الديار العربية في أخريات القرن الثامن عشر. وتكوينه في هذا الشأن هو التكوين الذي تلقاه بلغاء اللغة العربية في الزمن الماضي، أولئك الذين كانوا يأخذون بأسباب المبدإ البلاغي القائل: "إن من ملك الفصل والوصل فقد ملك اللغة العربية".
حين نقرأ طه حسين نجده يستخدم كلمات لا يوظفها إلا أولئك الذين وهبهم الله نعمة البصر. أجل، تواجهنا تعابير مثل: "ما رأيت قبلك كذا وكذا.." " رأيت بسمته رؤية العين"، "شهدت مصرعها.." "مأساة شهدناها معا.."
"أمد عيني إلى المرآة." "المرآة تحسن الإفصاح مثل العيون.." "أطيل النظر إليه.." "كنت أرى أختي تشب.." "رفعت عينيها إلى السماء" إلخ. وهي، مثلما نلاحظ، تعابير تجسد المرئيات التي يعرف كيف يصفها وصفا دقيقا وكأنه إنسان مبصر فعلا.
وعليه، فإن كلمة "أرى" ذات حدين اثنين يشيران إما إلى ما هو ذهني خالص، أو إلى ماهو فيزيولوجي صرف، وشأن طه حسين في ذلك شأن من يشعر أنه يتمتع بقوة الإبصار حقا وصدقا. وقارئه يتقبل منه هذا السلوك التعبيري ويرى فيه أمرا طبيعيا عاديا.
ولذلك أمكن القول إن طه حسين قد عرف كيف يعوض عن عاهته تلك بالإستناد إلى الجملة الطويلة، تلك التي تتميز بأسماء الموصول دون أن ينفر منه قارئه. لقد وجد بذكائه الحاد سبيلا يسير عليها دون أن يتعثر أو يضطرب، وهي سبيل الأسلوب الرائق المحمول على متن جملة ذات نفس طويل. ولولا أن قارئه يعرف عنه مسبقا أنه يقرأ لكاتب ضرير لما شعر بتلك العاهة في صلب جميع ما كتبه.
مارسيل بروست يعوض بدوره عن ضيق التنفس الناجم عن داء الربو موظفا الجملة الطويلة والسرد الذي لا يكاد يتوقف إلا لكي يستأنف انطلاقته بنفس الإيقاع وكأنه أحد عدائي المسافات الطويلة. لقد تمكن من تحويل اللغة إلى ما يشبه أنبوبة أوكسيجين تساعده على التنفس الطبيعي.
يتحدث طه حسين عن نفسه في سيرته الذاتية "الأيام" فيصف لنا كيف كان في صباه الأول يخرج من دار والديه، وينطلق متلمسا السياج، ثم يمضي محاذيا القصب إلى أن يبلغ ترعة النهر. هذا هو طه حسين أيامذاك. إنه ذلك الصبي الذي لم يختلف إلى الكتاب بعد. لكن، حين يأخذ بأسباب العلم نراه يتحدث عن قوة الإبصار وكأنه إنسان مبصر فعلا، لم تصبه أية عاهة. لعله أدرك ضرورة أن يعرف الناس عنه أو القراء أنه تجاوز عاهته وحدودها، وصار يعيش كغيره من الناس المبصرين. ولذلك، نراه يستخدم كلمة "رأى" استخداما تلقائيا وذلك بمعنييها العقلي والفيزيولوجي. وهولا يتوقف عند هذا الحد، بل يجعل من اللغة أو من الأسلوب آلة يستعين بها على قضاء ما يريده من حاجات في مضمار التعبير الأدبي، ومن ثم، في التعويض عن النقص الذي شعر به في صدر طفولته. هو عندئذ يوظف اللغة على غرار ما يفعله النجار حين يستخدم آلة لقطع الخشب، أو البناء الذي يرقى على سلم لكي يبلغ ارتفاعا معينا ليواصل عملية البناء. اللغة عنده عبارة عن سند خارجي يعوض به ما نقص منه أو فاته على الصعيد الفيزيولوجي.
مارسيل بروست يفعل نفس الشيء، ولكن في جانب آخر، بمعنى أنه - وهو الذي تعذب طيلة حياته بسبب داء الربو- يريد في قرارة نفسهأن يعوض عجزه عن التنفس ويستقدم إلى رئتيه الأوكسيجين الذي افتقر إليه دائما وأبدا. لكن هذا التعويض يتم أيضا عبر اللغة وعبر الجملة الطويلة التي استطاع أن يوظفها دون عناء ودون أن يثقل على نفسه أو على قارئه. وبالفعل، لا نكاد نشعر بما يعانيه في أثناء مطالعتنا لما كتبه، إذ أنه لا يشير إلى مرضه إلا في مستهل روايته النهرية حين يرسل جملته الأولى قائلا: "لوقت طويل وأنا آوي إلى النوم في ساعة مبكرة.." وتمضي به الحال على نفس الإيقاع إلى أن يضع كلمة الختام في روايته هذه، أي، بعد ثمانية أجزاء كاملة. ولعل الظن قد ذهب به بعد أن وضع نقطة النهاية إلى أنه سيسلك سلوك الأصحاء من الناس، لكنه اكتشف تحت وطأة السرور الغامر أنه أعجز ما يكون عن التنفس العادي فقال لخادمته: "لقد آن لي أن أرتاح! ". لو أنه وظف هذه الجملة بطريقته الأسلوبية المعهودة لاستغرق منه الأمر مئات الصفحات أيضا.
ينسب مارسيل إلى ما يسمى بـ"مدرسة تيار الوعي" في السرد الروائي إلى جانب كل من "فرجينيا وولف، Virginia Woolfe 1941-1882" و" جيمس جويس James Joyce 1941-1882". قد يكون المنطلق واحدا بينه وبين هذين الروائيين، لكنه يتميز عنهما بأنه جعل من الأسلوب سندا طبيعيا له في حياته. لقد عاش بفضل جملته الطويلة حياة جديدة جعلته قريبا من الناس، بله الأدباء بالرغم من القلق الذي ظل يستبد به كلماشعر بالحاجة إلى الإخلاد إلى النوم. إنه عندئذ يعود إلى مرضه بعد أن طرحه جانبا وامتطى متن الجملة الطويلة لمدة ساعات وساعات، فتنفس بصورة طبيعية حتى وإن هو أحس بضرورة أن ينكمش على نفسه في غرفتة التي بلطها بالفلين. ما عاد – على ما يبدو من تفاصيل روايته – يمضي ليله معذبا، مؤرقا على جري عادته في بداية حياته الأدبية، منتظرا أن يسفر الصبح لكي يستأنف دورة عيشه العادية إلى جانب الناس الآخرين. وعندما مضت به الأيام على هذه الشاكلة من العذاب، وجد الحل أو الترياق بأن صار يقضي لياليه كلها منكبا على دفاتره ليصوغ روايته، بل إنه ما عاد يشعر بالحاجة إلى مغادرة فراشه اللهم إلا لقضاء بعض الحاجات الضرورية. وفيما عدا ذلك فإنه يتناول طعامه وشرابه على سريره، ولا يحس بأي داع إلى أن يختلف إلى غيره من الناس ويجالسهم في المطاعم الباريسية الرائقة مثلما فعل دائما عندما كان يقوى على الخروج ليلا والسهر حتى الصباح لكي ينسى مرضه. الجملة الطويلة التلقائية هي التي أنسته وطأة داء الربو وما يحدثه من ضيق في التنفس.
ولذلك طالت روايته النهرية لأنها صارت بالنسبة له ما يشبه أنبوبة الأوكسيجين التي يستخدمها عندما تضيق أنفاسه. ولذلك أيضا تمكن من أن يجعل من الفكرة الواحدة بحرا من الكلمات يكاد يكون بلا ساحل، وينتقل من ذلك البحر إلى بحر آخر على مدى أكثر من ثلاثة آلاف صفحة.
كذلك الشأن بالنسبة لطه حسين الذي تعددت كتاباته في السرد الروائي والنقد الأدبي والتاريخ والترجمة عن الفرنسية واليونانية. لكأننا به يعود إلى حياة الناس العاديين دون أن يشعر بعاهته، فينطلق في الكتابة دون توقف، مدركا ضرورة تنظيم وقته من أجل إملاء ما يريد إملاءه على كاتبه الخاص. إنه عندئذ يسلك سلوك أي إنسان مبصر. وهو في هذا الشأن يستخدم الجملة الطويلة بطريقته الخاصة، تلك التي يوظف فيها الكثير من أسماء الموصول والصفات والنعوت ضمن تشكيلة موسيقية فريدة من نوعها في النثر العربي الحديث.
ليس هناك في كتابات مارسيل بروست ما يشير إلى أنه كان على اطلاع بما وضعه " سيجموند فرويدSigmund Freud(1939-1856)" في مجال التحليل النفسي بالرغم من أنه كان مجايلا له، وبالرغم من أنه عني عناية فائقة بتصوير نفسيات أولئك الذين كانوا يرتادون المجتمعات الراقية والسهرات المخملية ما بين 1880 و1913. لقد وضع نفسه موضع الصدارة في روايته، وحلل من خلالها المجتمع الفرنسي، وعليه، فإن تلقائيته تلك إنما جاءت وليدة ما يحس به من ضرورة التنفيس عن آلامه دون أن يفكر في الانطلاق من هذا المنهج النفساني أو ذاك. ومن المعروف عنه أنه بدأ الكتابة ناقدا لسانت بوف Sainte-Beuve(1869-1804)، ومتأملا في شؤون المطالعة والجماليات. لكنه عندما استذكر ذات يوم قطعة المادلينه" المغطوسة في منقوع الشاي حدثت النقلة العجيبة في أعماق نفسه، فاتخذ سبيلا أخرى في مجال التعبير الأدبي. هكذا عمل على أن ينسى مرضه عبر الكتابة مؤملا دون شك أن يتنفس بملء رئتيه في أثناء الكتابة ألإبداعية التي كانت تستغرق منه ساعات وساعات، بل والليل بطوله، ولا يكاد ينام إلا سحابة نهاره ليستيقظ حين يجن الليل فيعاود الانطلاق في الكتابة، أي، لكي يتنفس بصورة تكاد تكون طبيعية إن جاز قول ذلك. ولعل أجمل ما في رواية بروست هذه إنما هو الجانب الموسيقي الذي تتميز به جملته الطويلة. لم يكن مقتنعا بضرورة أن ينفس عن ألمه فحسب، بل، كان ميالا إلى أن يصحب ذلك بإيقاع نابع من تركيبة الجملة الطويلة نفسها أكثر مما هو نابع أو متأثر بالمقطوعات الموسيقية الكلاسيكية التي سبق له أن أنصت إلهيا خلال سهراته المخملية السابقة أو لدى بعض أصحابه من العازفين من أمثال رينالدو هان () وكلود دوبيسي () وموريس رافيل (). كل ذلك متكامل عنده، لا نشاز فيه. كان يريد لوسامته ولأناقته أن تنعكسا على حياته كلها وعلى أسلوبه في الكتابة. وبالفعل، فهو عندما بدأ يشعر باشتداد وطأة المرض عليه راح يعزل نفسه شيئا فشيئا عن الناس ويحصر نفسه في غرفته حصرا لكي لا تنال منه أدنى هبة من هواء فتؤثر في شعبه الرئوية. الكتابة السردية عنده انعكاس لما ظل يشعر به من ميل إلى أن يعب الهواء بكامل رئتيه. ولا شك في أنه نجح في هذا الأمر، إذ أننا في أثناء قراءتنا لروايته النهرية لا نشعر بأنه مهموم بمرضه مثلما كان عليه في بداية الأمر. لقد اكتفى بأن أشار إلى ذلك حين استهل روايته بجملته الشهيرة : (لمدة طويلة وأنا آوي إلى فراشي في ساعة مبكرة.." كما أنه لم يطل الحديث عن الأرق الذي ينتابه بمجرد أن يستلقي في فراشه، ثم ينسى ذلك أو هو يتناساه. وهو قد يشير إلى مرضه ذاك إشارات خفيفة هنا وهناك في صلب روايته، ولكن دون التركيز عليه، لأنه يكون في أثناء الكتابة قد وضع ما يشبه قناع الأوكسجين على وجهه بفضل الجملة الطويلة المنغمة التي لا يوجد لها مثيل في الأدب السردي الفرنسي كله. فنحن لا نجد مثيلا لها بالفعل عند الناثر العظيم " ألفونس دو شاتوبريان Alphonse de Chateaubriand(1848-1768)، الذي كان يكتب بتلقائية مذهلة، ولا عند الروائي الفذ جوستاف فلوبير Gustave Flaubert (1880-1821) الذي كان ينحت جمله نحتا، ولا عند الروائي الكبير " فرانسوا مورياك (1885-1970)" ذلك الذي لا يقل قدرة على التعبير الأدبي الدقيق.
لقد كان طه حسين أشبه بالقرين لمارسيل بروست، لكننا لا نكاد نعثر على أية إشارة في كتاباته النقدية إلى أنه قرأ روايته النهرية بالرغم من أنه اطلع على الكثير من عيون الأدب الفرنسي خاصة منها ما كتبه "أندري جيد André Gide(1951-1868) و"بول فاليري PAUL Valéry (1871-1945" وغيرهما. طه حسين يمضي في السرد ولكنه لا يتأثر بغيره من الناثرين الأقدمين. تأثره في هذا الشأن إنما كان بالشعراء على ما يظهر في جميع ما كتبه. حين يملي كتاباته يصير مبصرا ويزداد قوة إبصار حين يستخدم أسلوبه النثري الرشيق الذي يعتمد فيه على استخدام الموصولات وعلى الإطناب وعلى النعوت والأوصاف التي كثيرا ما تتكرر هنا وهناك ولكن في سياق متناغم بديع.
ويبدو أن طه حسين قد أفلت من تأثير أبي العلاء المعري فيه على الصعيد الأسلوبي بالرغم من أنه بدا حياته عاشقا له ولشعره ولرؤيته الفلسفية. لكنه سرعان ما انفصل عنه خاصة بعد أن ذهب للدراسة في باريس وعاد منها محملا بشهادة الدكتوراه. نلمس ذلك في سيرته الذاتية "الأيام" بأجزائها الثلاثة، وفي مواضيعه النقدية والتاريخية والاجتماعية. إنه لا يكاد يشير إلى أنه ابتلي بعاهة فقدان البصر. ولا يقول عن نفسه إنه رهين هذا المحبس أو ذاك على غرار ما فعله أبو العلاء المعري. لقد وجد ما يشبه العكاز الذي يتوكأ عليه في حياته الجديدة، ونعني به اللغة أو الجملة الطويلة التي يتفنن في أناقتها ورشاقتها.
يقول عالم الدلالات الفرنسي "رولان بارت (1915-1980 Roland Barthes" في كتابه الأول "درجة الصفر في الكتابة" الذي أصدره عام 1953 أن هناك جوانب لا تكشف عنها اللغة، إنما الاستعمال المتميز لدى هذا الكاتب أو ذاك هو الذي يمكن من إضافة أشياء جديدة غير معروفة في عالم اللغة. اللغة بمعناها العام أو بمعناها الخاص الذي يتحدث عنه عالم اللسانيات، "فرديناند دوسوسير Ferdinand de Saussure()"، عبارة عن وعاء يمكن أن يحتوي كل شيء وكل ما لم نعرفه بعد. وعليه، فهي لدى طه حسين وسيلة من وسائل المشاركة في العيش بصورة طبيعية، لا نكاد نعثر فيها على أثر لعاهته. وقد أثبت ذلك في مجموع كتاباته بحيث إن القارىء قلما يشعر أنه يطالع كتابا لانسان ضرير. وكذلك الشأن بالنسبة لمارسيل بروست، فلقد صارت عنده ما يشبه رئتين سليمتين يتنفس بهما حتى وإن هجر العيش في النهار وآثر العيش في قلب الليل البهيم بمفرده كاتبا مدبجا روايته دونما توقف. من يدري، فقد يطلع الإنسان في القادم من الأيام بمكتشفات جديدة لم تفصح عنها اللغة منذ أن استخدم هذا الانسان هذه الوسيلة العجيبة في الاتصال. اننا لا نعلم كيف كان هوميروس يعمل وينظم ملحمتيه الخالدتين، ولا نعرف كبير شيء عن طريقة جون ميلتون، John Milton(1674-1608) في النظم، كما أننا لا نكاد نعرف إلا النزر اليسير عن طريقة جورج لويس بورجيس Borgès(1986-1899) في الكتابة القصصية بالرغم من أنه معاصر لنا. هؤلاء كلهم كانوا ضريرين ولكنهم استخدموا اللغة وجعلوا منها جسرا يمضون عليه كغيرهم من البشر الآخرين العاديين.
ويظل التعبير الأدبي أولا وقبل كل شيء الوسيلة المثلى لاكتشاف أمور لم تصل إليها العلوم الدقيقة بعد.
هل قضى عليه الإبداع الأدبي حقا، أم إنه أطال عمره؟ إذا كان قرينه العربي،- في جانب آخر -، ونعني به الدكتور طه حسين (1889-1973) قد سار على نهجه في مضمار السرد القصصي، مع فارق كبير بينهما، بدءا من سيرته الذاتية "الأيام" ومرورا بـ"أديب" و"المعذبون في الأرض" و"دعاء الكروان"، فإنه لم يبد عليه أنه تأثر به على الرغم من أنه كان على اطلاع دقيق بتحف الأدب الفرنسي. لكن، يمكن القول إنه حذا حذوه في الجانب الأسلوبي، أي، في النفس الطويل الذي تميزت به جملته العربية الأنيقة.
لكأننا بكل من هذين الأديبين العملاقين قد سارا في خط واحد على صعيد الأسلوب. مارسيل بروست يأخذ بأسباب الجملة الطويلة ولا يكاد يضع نقطة النهاية في هذه الجملة أو تلك إلا بعد أن يشعر بالحاجة إلى أخذ نفس جديد، متكئا في ذلك على الجانب الإيقاعي الذي يحسن التحكم فيه بحيث لا يكاد القارىء ينفر من أسلوبه، بل يسايره وكأنه قبالة جدول رقراق ينساب هادئا، معرجا على هذه الصخرة أو تلك، مدللا بذلك على نفسية الكاتب بالذات. وهل من عجب إذا ما عرفنا أن مارسيل بروست هو صاحب أطول جملة نثرية في الأدب الفرنسي بحيث إنها بلغت 243 كلمة؟ ولكأننا أيضا بطه حسين يفعل نفس الشيء دون أن يبعث قارئه على الملل أو النفور من أسلوبه، سواء أكتب الرواية أم عالج البحث الاجتماعي- التاريخي أم النقد الأدبي.
حين نتمعن في التقنية الأسلوبية لدى هذين الأديبين نجد أنفسنا مدفوعين إلى القول إن المرض الذي أصيب به مارسيل بروست منذ صباه الأول، أي، داء الربو، وعاهة العمى التي مني بها طه حسين منذ سن الثالثة، هما في كلتا الحالتين وراء ميلهما التلقائي إلى الأخذ بنفس الأسلوب السردي، أي الجملة الطويلة.
تمكن طه حسين من علوم العربية بطريقة كلاسيكية، أي عن طريق السماع. وفي هذا الجانب على وجه التحديد ساعده فقدان بصره على امتلاك ناصية اللغة العربية وفقا للطريقة المعتمدة في التراث العربي القديم، بمعنى أنه ما كان يشعر بالحاجة إلى استخدام أسباب التنقيط المعروفة التي فرضت نفسها في اللغة العربية منذ أن دخلت المطبعة إلى الديار العربية في أخريات القرن الثامن عشر. وتكوينه في هذا الشأن هو التكوين الذي تلقاه بلغاء اللغة العربية في الزمن الماضي، أولئك الذين كانوا يأخذون بأسباب المبدإ البلاغي القائل: "إن من ملك الفصل والوصل فقد ملك اللغة العربية".
حين نقرأ طه حسين نجده يستخدم كلمات لا يوظفها إلا أولئك الذين وهبهم الله نعمة البصر. أجل، تواجهنا تعابير مثل: "ما رأيت قبلك كذا وكذا.." " رأيت بسمته رؤية العين"، "شهدت مصرعها.." "مأساة شهدناها معا.."
"أمد عيني إلى المرآة." "المرآة تحسن الإفصاح مثل العيون.." "أطيل النظر إليه.." "كنت أرى أختي تشب.." "رفعت عينيها إلى السماء" إلخ. وهي، مثلما نلاحظ، تعابير تجسد المرئيات التي يعرف كيف يصفها وصفا دقيقا وكأنه إنسان مبصر فعلا.
وعليه، فإن كلمة "أرى" ذات حدين اثنين يشيران إما إلى ما هو ذهني خالص، أو إلى ماهو فيزيولوجي صرف، وشأن طه حسين في ذلك شأن من يشعر أنه يتمتع بقوة الإبصار حقا وصدقا. وقارئه يتقبل منه هذا السلوك التعبيري ويرى فيه أمرا طبيعيا عاديا.
ولذلك أمكن القول إن طه حسين قد عرف كيف يعوض عن عاهته تلك بالإستناد إلى الجملة الطويلة، تلك التي تتميز بأسماء الموصول دون أن ينفر منه قارئه. لقد وجد بذكائه الحاد سبيلا يسير عليها دون أن يتعثر أو يضطرب، وهي سبيل الأسلوب الرائق المحمول على متن جملة ذات نفس طويل. ولولا أن قارئه يعرف عنه مسبقا أنه يقرأ لكاتب ضرير لما شعر بتلك العاهة في صلب جميع ما كتبه.
مارسيل بروست يعوض بدوره عن ضيق التنفس الناجم عن داء الربو موظفا الجملة الطويلة والسرد الذي لا يكاد يتوقف إلا لكي يستأنف انطلاقته بنفس الإيقاع وكأنه أحد عدائي المسافات الطويلة. لقد تمكن من تحويل اللغة إلى ما يشبه أنبوبة أوكسيجين تساعده على التنفس الطبيعي.
يتحدث طه حسين عن نفسه في سيرته الذاتية "الأيام" فيصف لنا كيف كان في صباه الأول يخرج من دار والديه، وينطلق متلمسا السياج، ثم يمضي محاذيا القصب إلى أن يبلغ ترعة النهر. هذا هو طه حسين أيامذاك. إنه ذلك الصبي الذي لم يختلف إلى الكتاب بعد. لكن، حين يأخذ بأسباب العلم نراه يتحدث عن قوة الإبصار وكأنه إنسان مبصر فعلا، لم تصبه أية عاهة. لعله أدرك ضرورة أن يعرف الناس عنه أو القراء أنه تجاوز عاهته وحدودها، وصار يعيش كغيره من الناس المبصرين. ولذلك، نراه يستخدم كلمة "رأى" استخداما تلقائيا وذلك بمعنييها العقلي والفيزيولوجي. وهولا يتوقف عند هذا الحد، بل يجعل من اللغة أو من الأسلوب آلة يستعين بها على قضاء ما يريده من حاجات في مضمار التعبير الأدبي، ومن ثم، في التعويض عن النقص الذي شعر به في صدر طفولته. هو عندئذ يوظف اللغة على غرار ما يفعله النجار حين يستخدم آلة لقطع الخشب، أو البناء الذي يرقى على سلم لكي يبلغ ارتفاعا معينا ليواصل عملية البناء. اللغة عنده عبارة عن سند خارجي يعوض به ما نقص منه أو فاته على الصعيد الفيزيولوجي.
مارسيل بروست يفعل نفس الشيء، ولكن في جانب آخر، بمعنى أنه - وهو الذي تعذب طيلة حياته بسبب داء الربو- يريد في قرارة نفسهأن يعوض عجزه عن التنفس ويستقدم إلى رئتيه الأوكسيجين الذي افتقر إليه دائما وأبدا. لكن هذا التعويض يتم أيضا عبر اللغة وعبر الجملة الطويلة التي استطاع أن يوظفها دون عناء ودون أن يثقل على نفسه أو على قارئه. وبالفعل، لا نكاد نشعر بما يعانيه في أثناء مطالعتنا لما كتبه، إذ أنه لا يشير إلى مرضه إلا في مستهل روايته النهرية حين يرسل جملته الأولى قائلا: "لوقت طويل وأنا آوي إلى النوم في ساعة مبكرة.." وتمضي به الحال على نفس الإيقاع إلى أن يضع كلمة الختام في روايته هذه، أي، بعد ثمانية أجزاء كاملة. ولعل الظن قد ذهب به بعد أن وضع نقطة النهاية إلى أنه سيسلك سلوك الأصحاء من الناس، لكنه اكتشف تحت وطأة السرور الغامر أنه أعجز ما يكون عن التنفس العادي فقال لخادمته: "لقد آن لي أن أرتاح! ". لو أنه وظف هذه الجملة بطريقته الأسلوبية المعهودة لاستغرق منه الأمر مئات الصفحات أيضا.
ينسب مارسيل إلى ما يسمى بـ"مدرسة تيار الوعي" في السرد الروائي إلى جانب كل من "فرجينيا وولف، Virginia Woolfe 1941-1882" و" جيمس جويس James Joyce 1941-1882". قد يكون المنطلق واحدا بينه وبين هذين الروائيين، لكنه يتميز عنهما بأنه جعل من الأسلوب سندا طبيعيا له في حياته. لقد عاش بفضل جملته الطويلة حياة جديدة جعلته قريبا من الناس، بله الأدباء بالرغم من القلق الذي ظل يستبد به كلماشعر بالحاجة إلى الإخلاد إلى النوم. إنه عندئذ يعود إلى مرضه بعد أن طرحه جانبا وامتطى متن الجملة الطويلة لمدة ساعات وساعات، فتنفس بصورة طبيعية حتى وإن هو أحس بضرورة أن ينكمش على نفسه في غرفتة التي بلطها بالفلين. ما عاد – على ما يبدو من تفاصيل روايته – يمضي ليله معذبا، مؤرقا على جري عادته في بداية حياته الأدبية، منتظرا أن يسفر الصبح لكي يستأنف دورة عيشه العادية إلى جانب الناس الآخرين. وعندما مضت به الأيام على هذه الشاكلة من العذاب، وجد الحل أو الترياق بأن صار يقضي لياليه كلها منكبا على دفاتره ليصوغ روايته، بل إنه ما عاد يشعر بالحاجة إلى مغادرة فراشه اللهم إلا لقضاء بعض الحاجات الضرورية. وفيما عدا ذلك فإنه يتناول طعامه وشرابه على سريره، ولا يحس بأي داع إلى أن يختلف إلى غيره من الناس ويجالسهم في المطاعم الباريسية الرائقة مثلما فعل دائما عندما كان يقوى على الخروج ليلا والسهر حتى الصباح لكي ينسى مرضه. الجملة الطويلة التلقائية هي التي أنسته وطأة داء الربو وما يحدثه من ضيق في التنفس.
ولذلك طالت روايته النهرية لأنها صارت بالنسبة له ما يشبه أنبوبة الأوكسيجين التي يستخدمها عندما تضيق أنفاسه. ولذلك أيضا تمكن من أن يجعل من الفكرة الواحدة بحرا من الكلمات يكاد يكون بلا ساحل، وينتقل من ذلك البحر إلى بحر آخر على مدى أكثر من ثلاثة آلاف صفحة.
كذلك الشأن بالنسبة لطه حسين الذي تعددت كتاباته في السرد الروائي والنقد الأدبي والتاريخ والترجمة عن الفرنسية واليونانية. لكأننا به يعود إلى حياة الناس العاديين دون أن يشعر بعاهته، فينطلق في الكتابة دون توقف، مدركا ضرورة تنظيم وقته من أجل إملاء ما يريد إملاءه على كاتبه الخاص. إنه عندئذ يسلك سلوك أي إنسان مبصر. وهو في هذا الشأن يستخدم الجملة الطويلة بطريقته الخاصة، تلك التي يوظف فيها الكثير من أسماء الموصول والصفات والنعوت ضمن تشكيلة موسيقية فريدة من نوعها في النثر العربي الحديث.
ليس هناك في كتابات مارسيل بروست ما يشير إلى أنه كان على اطلاع بما وضعه " سيجموند فرويدSigmund Freud(1939-1856)" في مجال التحليل النفسي بالرغم من أنه كان مجايلا له، وبالرغم من أنه عني عناية فائقة بتصوير نفسيات أولئك الذين كانوا يرتادون المجتمعات الراقية والسهرات المخملية ما بين 1880 و1913. لقد وضع نفسه موضع الصدارة في روايته، وحلل من خلالها المجتمع الفرنسي، وعليه، فإن تلقائيته تلك إنما جاءت وليدة ما يحس به من ضرورة التنفيس عن آلامه دون أن يفكر في الانطلاق من هذا المنهج النفساني أو ذاك. ومن المعروف عنه أنه بدأ الكتابة ناقدا لسانت بوف Sainte-Beuve(1869-1804)، ومتأملا في شؤون المطالعة والجماليات. لكنه عندما استذكر ذات يوم قطعة المادلينه" المغطوسة في منقوع الشاي حدثت النقلة العجيبة في أعماق نفسه، فاتخذ سبيلا أخرى في مجال التعبير الأدبي. هكذا عمل على أن ينسى مرضه عبر الكتابة مؤملا دون شك أن يتنفس بملء رئتيه في أثناء الكتابة ألإبداعية التي كانت تستغرق منه ساعات وساعات، بل والليل بطوله، ولا يكاد ينام إلا سحابة نهاره ليستيقظ حين يجن الليل فيعاود الانطلاق في الكتابة، أي، لكي يتنفس بصورة تكاد تكون طبيعية إن جاز قول ذلك. ولعل أجمل ما في رواية بروست هذه إنما هو الجانب الموسيقي الذي تتميز به جملته الطويلة. لم يكن مقتنعا بضرورة أن ينفس عن ألمه فحسب، بل، كان ميالا إلى أن يصحب ذلك بإيقاع نابع من تركيبة الجملة الطويلة نفسها أكثر مما هو نابع أو متأثر بالمقطوعات الموسيقية الكلاسيكية التي سبق له أن أنصت إلهيا خلال سهراته المخملية السابقة أو لدى بعض أصحابه من العازفين من أمثال رينالدو هان () وكلود دوبيسي () وموريس رافيل (). كل ذلك متكامل عنده، لا نشاز فيه. كان يريد لوسامته ولأناقته أن تنعكسا على حياته كلها وعلى أسلوبه في الكتابة. وبالفعل، فهو عندما بدأ يشعر باشتداد وطأة المرض عليه راح يعزل نفسه شيئا فشيئا عن الناس ويحصر نفسه في غرفته حصرا لكي لا تنال منه أدنى هبة من هواء فتؤثر في شعبه الرئوية. الكتابة السردية عنده انعكاس لما ظل يشعر به من ميل إلى أن يعب الهواء بكامل رئتيه. ولا شك في أنه نجح في هذا الأمر، إذ أننا في أثناء قراءتنا لروايته النهرية لا نشعر بأنه مهموم بمرضه مثلما كان عليه في بداية الأمر. لقد اكتفى بأن أشار إلى ذلك حين استهل روايته بجملته الشهيرة : (لمدة طويلة وأنا آوي إلى فراشي في ساعة مبكرة.." كما أنه لم يطل الحديث عن الأرق الذي ينتابه بمجرد أن يستلقي في فراشه، ثم ينسى ذلك أو هو يتناساه. وهو قد يشير إلى مرضه ذاك إشارات خفيفة هنا وهناك في صلب روايته، ولكن دون التركيز عليه، لأنه يكون في أثناء الكتابة قد وضع ما يشبه قناع الأوكسجين على وجهه بفضل الجملة الطويلة المنغمة التي لا يوجد لها مثيل في الأدب السردي الفرنسي كله. فنحن لا نجد مثيلا لها بالفعل عند الناثر العظيم " ألفونس دو شاتوبريان Alphonse de Chateaubriand(1848-1768)، الذي كان يكتب بتلقائية مذهلة، ولا عند الروائي الفذ جوستاف فلوبير Gustave Flaubert (1880-1821) الذي كان ينحت جمله نحتا، ولا عند الروائي الكبير " فرانسوا مورياك (1885-1970)" ذلك الذي لا يقل قدرة على التعبير الأدبي الدقيق.
لقد كان طه حسين أشبه بالقرين لمارسيل بروست، لكننا لا نكاد نعثر على أية إشارة في كتاباته النقدية إلى أنه قرأ روايته النهرية بالرغم من أنه اطلع على الكثير من عيون الأدب الفرنسي خاصة منها ما كتبه "أندري جيد André Gide(1951-1868) و"بول فاليري PAUL Valéry (1871-1945" وغيرهما. طه حسين يمضي في السرد ولكنه لا يتأثر بغيره من الناثرين الأقدمين. تأثره في هذا الشأن إنما كان بالشعراء على ما يظهر في جميع ما كتبه. حين يملي كتاباته يصير مبصرا ويزداد قوة إبصار حين يستخدم أسلوبه النثري الرشيق الذي يعتمد فيه على استخدام الموصولات وعلى الإطناب وعلى النعوت والأوصاف التي كثيرا ما تتكرر هنا وهناك ولكن في سياق متناغم بديع.
ويبدو أن طه حسين قد أفلت من تأثير أبي العلاء المعري فيه على الصعيد الأسلوبي بالرغم من أنه بدا حياته عاشقا له ولشعره ولرؤيته الفلسفية. لكنه سرعان ما انفصل عنه خاصة بعد أن ذهب للدراسة في باريس وعاد منها محملا بشهادة الدكتوراه. نلمس ذلك في سيرته الذاتية "الأيام" بأجزائها الثلاثة، وفي مواضيعه النقدية والتاريخية والاجتماعية. إنه لا يكاد يشير إلى أنه ابتلي بعاهة فقدان البصر. ولا يقول عن نفسه إنه رهين هذا المحبس أو ذاك على غرار ما فعله أبو العلاء المعري. لقد وجد ما يشبه العكاز الذي يتوكأ عليه في حياته الجديدة، ونعني به اللغة أو الجملة الطويلة التي يتفنن في أناقتها ورشاقتها.
يقول عالم الدلالات الفرنسي "رولان بارت (1915-1980 Roland Barthes" في كتابه الأول "درجة الصفر في الكتابة" الذي أصدره عام 1953 أن هناك جوانب لا تكشف عنها اللغة، إنما الاستعمال المتميز لدى هذا الكاتب أو ذاك هو الذي يمكن من إضافة أشياء جديدة غير معروفة في عالم اللغة. اللغة بمعناها العام أو بمعناها الخاص الذي يتحدث عنه عالم اللسانيات، "فرديناند دوسوسير Ferdinand de Saussure()"، عبارة عن وعاء يمكن أن يحتوي كل شيء وكل ما لم نعرفه بعد. وعليه، فهي لدى طه حسين وسيلة من وسائل المشاركة في العيش بصورة طبيعية، لا نكاد نعثر فيها على أثر لعاهته. وقد أثبت ذلك في مجموع كتاباته بحيث إن القارىء قلما يشعر أنه يطالع كتابا لانسان ضرير. وكذلك الشأن بالنسبة لمارسيل بروست، فلقد صارت عنده ما يشبه رئتين سليمتين يتنفس بهما حتى وإن هجر العيش في النهار وآثر العيش في قلب الليل البهيم بمفرده كاتبا مدبجا روايته دونما توقف. من يدري، فقد يطلع الإنسان في القادم من الأيام بمكتشفات جديدة لم تفصح عنها اللغة منذ أن استخدم هذا الانسان هذه الوسيلة العجيبة في الاتصال. اننا لا نعلم كيف كان هوميروس يعمل وينظم ملحمتيه الخالدتين، ولا نعرف كبير شيء عن طريقة جون ميلتون، John Milton(1674-1608) في النظم، كما أننا لا نكاد نعرف إلا النزر اليسير عن طريقة جورج لويس بورجيس Borgès(1986-1899) في الكتابة القصصية بالرغم من أنه معاصر لنا. هؤلاء كلهم كانوا ضريرين ولكنهم استخدموا اللغة وجعلوا منها جسرا يمضون عليه كغيرهم من البشر الآخرين العاديين.
ويظل التعبير الأدبي أولا وقبل كل شيء الوسيلة المثلى لاكتشاف أمور لم تصل إليها العلوم الدقيقة بعد.
